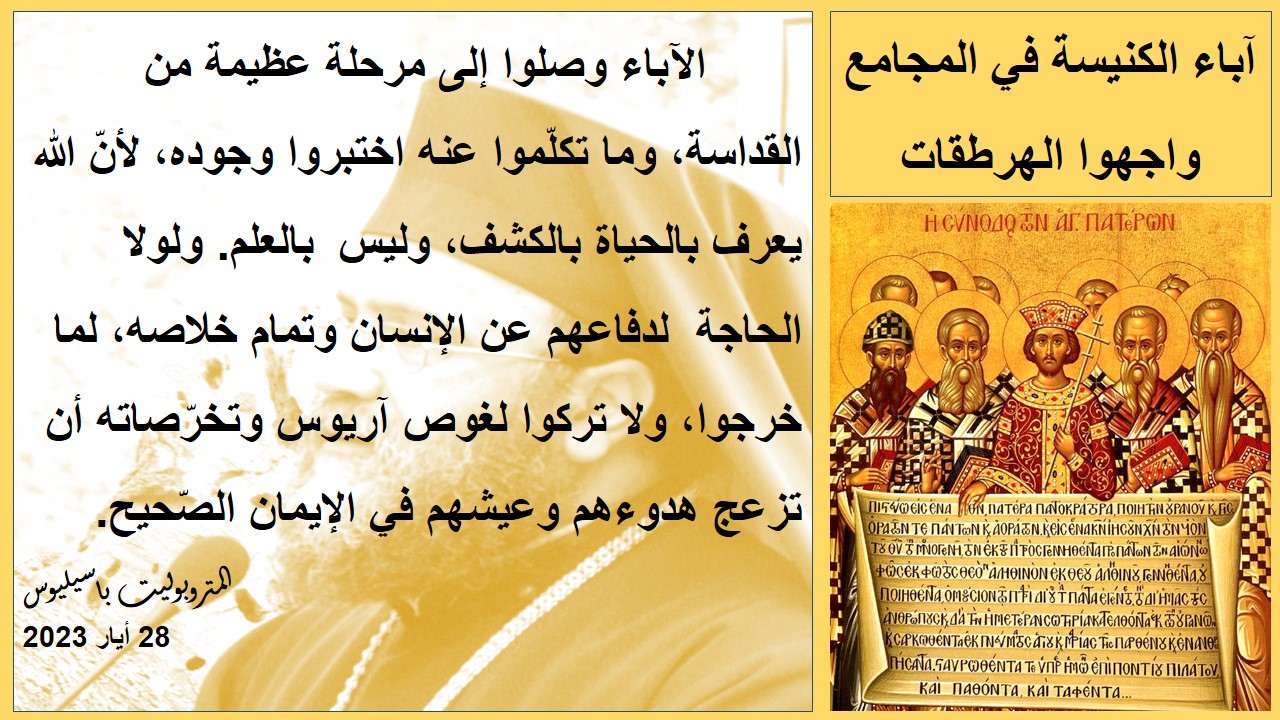هؤلاء الآباء كانوا قد وصلوا إلى مرحلة عظيمة من مراحل القداسة، وما تكلّموا عنه كانوا قد اختبروا وجوده مسبقًا، لأنّ الله يعرف بالحياة بالكشف، وليس بالعلم في الكتب والفلسفات والمجادلات. ولولا الحاجة لدفاعهم عن الإنسان وكماله غير المحدود وقيمته ، وتمام خلاصه، لما خرجوا، ولما أزعجوا أنفسهم، ولا تركوا لغوص آريوس وتخرّصاته أن تزعج هدوءهم وعيشهم في الإيمان الصّحيح الّذي يقود مراكبه الرّوح القدس، وبدونه لا يستطيع أحد أن يقول يسوع المسيح ربّ.
كلمة الرّاعي
سيادة المتروبوليت باسيليوس منصور الجزيل الاحترام
في افتتاحيّة البشارة
٢٨أيّار ٢٠٢٣
الإخوة والأبناء الأحبّاء،
في أحد الآباء تضع الكنيسة في ترتيبها اللّيتورجيّ قراءة النّصّ الإنجيليّ الّذي يتكلّم عن صلاة الرّبّ يسوع المسيح نحو الله الآب ليحفظ كنيسته، وشعبه ليكون واحدًا على صورة الله ومثاله.
ويبدو أنّه في هذه الصّلاة يخرج عن المألوف الّذي كان يعبّر فيه عن حبّه واهتمامه بكلّ الخليقة، بدون تمييز بين عبد أو حرّ، ملك أو عامل، رجل أو امرأة، لكنّه هنا يقول: "أنا من أجلهم أسأل، لا أسأل من أجل العالم، بل من أجل الّذين أعطيتهم لي لأنّهم لك".
لماذا هكذا فجأة يتكلّم الرّبّ يسوع المسيح بصلاةٍ حارّة من أجل جماعته الّذين معه، وليس من أجل العالم.
أوّلا، يجب أن ننتبه أنّ جماعة المؤمنين تحفظ الإيمان كما تسلّمته من الرّبّ يسوع المسيح، والحفاظ على الإيمان النّقيّ الطّاهر غير المعاب يبقي النّاس في حالة رؤية طبيعيّة، لا ضبابيّة فيها، ويسيرون بحسبها كما لو كانوا يسيرون في النّور.
وهؤلاء لا يتعثّرون في عبور هذه الحياة، لأنّ الإيمان أو العقائد الّتي تحتوي الإيمان، تشكّل سبل مسيرة الإنسان وعيشه، وتقونن تصرّفه. هذا الكلام بالنّسبة لعصرنا غريب على مسامع الكثيرين، ويخفى على أذهانهم، ولا يمكنهم اكتناه مستوراته.
لقد قال ربّنا يسوع المسيح "سيروا في النّور ما دام معكم النّور"، وهو النّور الآتي إلى العالم. هو يقود في طريق الحقّ، والحقّ يقود إليه. ومن مشى على هدي شريعته الّتي ليس من ناموس ضدّها سيتعامل ويعيش مع النّاس على أفضل الأحوال وأرتبها.
حياة الإنسان تصبحانعكاسًا للإيمان في حياته، "أرني إيمانك بدون أعمالك، وأنا أريك إيماني بأعمالي"، ويصبح الإنسان المؤمن أيضًا قدوة للنّاس. ولمّا كان عمل ربّنا يسوع المسيح أن يقودنا في موكب نصرته، حتّى نصل بالحقيقة إلى ملء قامته، فنحن لا نصل إلى ملء هذه القامة إلّا إذا شفينا بأكملنا، كما يقول القّديس غريعوريوس اللّاهوتيّ: "ما لم يتّخذ لا يشفى".
ونحن لا نخلص على صورة محدودة كما يفكر النّاس، بل خلاصنا هو في اكتساب الطّريق اكتسابًا صحيحًا لا نقص فيه ولا شائبة، ولا يستطيع أن يعطينا هذا الخلاص الّذي هدفه الكمال إلّا الكامل اّلذي لا يشوبه خطأ أو نقص، وهو الله سبحانه له المجد في العلا، وعلى الأرض، وعلى مدى الدّهور، والكلمة الإلهيّة وهي ربّنا يسوع المسيح المتجسد المساوي للآب في الجوهر، وهو ككلمة إلهيّة لا بداية، ولا نهاية له.
ولمّا أعلن آريوس أنّ الكلمة الإلهيّة غير كامل، وأن له بداية فقد وضع له نهاية استنفرت الكنيسة شرقًا وغربًا لا للدّفاع عن الله، فهو ليس بحاجة لدفاعنا، بل للدّفاع عن الإنسان، وخلاصه، وكماله في هذا الخلاص، فالإنسان مدعو أن يكون على ملء قامة ربّنا يسوع المسيح.
عقد المجمع المسكونيّ الأوّل سنة 325 في مدينة نيقية، لكي يحفظ للمؤمنين وحدتهم وحرّيّتهم، وإمكانيّة مسيرتهم نحو الكمال. وأعلن آباؤه خطأ كلام آريوس الّذي ينسف به ما أعلنه ربّنا يسوع المسيح "أنا والآب واحد من رآني فقد رأى الآب"، وتفَّوه آريوس بعبارات هي أقرب إلى الهراطقة الّذين سبقوه، والمعتمدين في شرح الإيمان على الفلسفات العالميّة كالأرسطويّة والأفلاطونيّة.
ولم يكن الآباء جميعًا على مستوى عالٍ من التّعليم والثّقافة والمعرفة، فقد كان منهم الكثيرون ممّن يعرفون القراءة والكتابة بالكاد. مثل القدّيس اسبيريدون، والقديس نيقولاوس، ولكن ذلك المجمع حوى العدد الأكبر من القدّيسين، وكانوا قد خرجوا لتوّهم من المعتقلات، والسّجون، وأعمال السّخرة الشّاقّة في مناجم الإمبراطوريّة.
هؤلاء الآباء كانوا قد وصلوا إلى مرحلة عظيمة من مراحل القداسة، وما تكلّموا عنه كانوا قد اختبروا وجوده مسبقًا، لأنّ الله يعرف بالحياة بالكشف، وليس بالعلم في الكتب والفلسفات والمجادلات. ولولا الحاجة لدفاعهم عن الإنسان وكماله غير المحدود وقيمته ، وتمام خلاصه، لما خرجوا، ولما أزعجوا أنفسهم، ولا تركوا لغوص آريوس وتخرّصاته أن تزعج هدوءهم وعيشهم في الإيمان الصّحيح الّذي يقود مراكبه الرّوح القدس، وبدونه لا يستطيع أحد أن يقول يسوع المسيح ربّ.
وكان بعضهم إلى حدّ ما، على درجة من العنف، يدفعهم لذلك الخوف على الكنيسة أي على المؤمنين الّذين هم جسد الرّبّ السّرّيّ أي كنيسته، وعلى خلاصهم. فوضعوا بالنّصّ المكتوب، وليس بالمعرفة المتوارثة كلّ ما يختصّ بربّنا يسوع المسيح، وبعمله الخلاصيّ، وهو ما نتلوه حتّى اليوم في دستور الإيمان من (أؤمن بإله واحد... حتى بداية العقيدة عن الرّوح القدس).
بالدّرجة الأولى دافعوا عن المؤمنين وخلاصهم.
ثانيًا، دافعوا عن وحدة المؤمنين. لأنّ عدم توضيح الإيمان وشرحه وتفسيره تفسيرًا صحيحًا، يجعلنا عرضة للتّفاسير المغرضة، وللانشقاقات والهرطقات، وبالتّالي للخصومات والتّباعد، والحقيقة واحدة لا ترى بأكثر من منظار واحد، ولا تظهر نفسها إلّا بمظهر واحد، وإلّا لكان المخّلص الّذي يتكلّم عنه الإنجيل، والعهد القديم قبله، غير الّذي تكلّم عنه الآباء في وجه الهراطقة. ولكانت حياة المؤمنين غير حياتهم ذات الاستقامة الّتي لا لبس فيها ولا تشويه. وهنا سآخذ مثلا بسيطًا من المجمع المسكوني الرابع 451.
قال أوطيخا رئيس أحد الأديار في القسطنطينيّة، إنّ لربّنا يسوع المسيح بعد التّجسّد طبيعة واحدة، وليس طبيعتان، لأنّ الطّبيعة الإلهيّة قد ابتلعت الطّبيعة البشريّة، كما يبتلع البحر كأس الماء. وبذات الغيرة، إجتمعت الكنيسة في خلقيدون، ودافعت ليس عن التّجسّد، بل عن موقع البشر وخلاصهم بالتّجسد. لأنّه إذا قبلنا أنّ الطّبيعة الإلهيّة قد ابتلعت الطّبيعة البشريّة وألغتها لكنّا نقبل في حياتنا أن يبتلع القويّ الضّعيف. ولو حدث تشوّش أو انقسام أو اختلاط لما كان خلاصنا على المستوى الإلهيّ. والإيمان غير الواحد يؤدّي إلى انقسامات وخصومات وشرور، لا تخفى على أحد شدّتها، وقوّة تأثيرها على علاقات الأمم والأفراد.
ونرجو من الله، ونحن في الشّرق الأوسط، ألّا نسمع، ولا نطيع الّذين يطيحون بوحدة الإيمان تحت تبريرات، وعلل الخطايا، لكي نبقى على قلب واحد، واعتراف واحد، ونصبح كلّنا واحدا في المسيح الّذي يقودنا، والّذي هو نورنا.
متروبوليت عكّار وتوابعها
باسيليوس